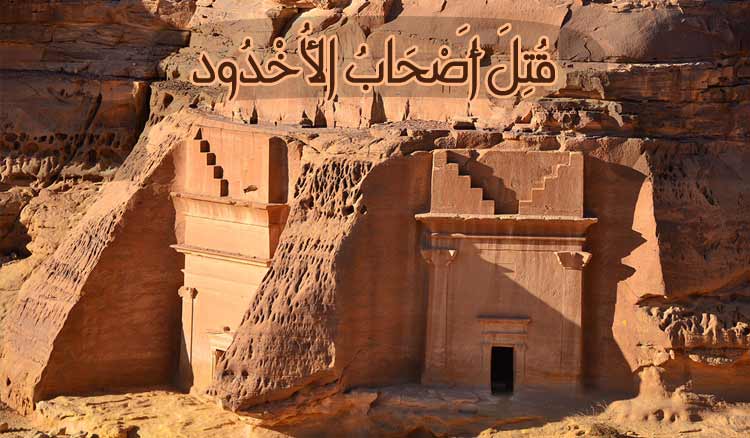من أسرار القرآن (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (العصر: 1-3)
من أسرار القرآن
مقالات جريدة الأهرام المصرية
(وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (العصر: 1-3)
بقلم الأستاذ الدكتور: زغلول راغب النجار
سورة العصر مكية، وهي من قصار سور القرآن الكريم؛ لاحتوائها على ثلاث آيات فقط بعد البسملة، وعلى الرغم من قصرها فهي تحوي المعالم الأساسية لرسالة الإنسان في هذه الحياة كما حددها له الله -تعالى-؛ فالإنسان عبد لله، خلقه ربنا -تبارك وتعالى- لرسالة محددة ذات وجهين: أولهما عبادة الله -تعالى- بما أمر، وثانيهما حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله فيها، ولايمكنه تحقيق ذلك بمفرده؛ إذ هو محتاج إلى التواصي على ذلك مع غيره من الناس: في بيته، وفي مجتمعه، وفي بلده، ومع أهل الأرض أجمعين، والتواصي بالصبر على ذلك لأن دعوة الناس إلى الحق تحتاج إلى كثير من المجاهدة والصبر، وهذا كله يأتي انطلاقا من الإيمان بإله واحد، هو خالق كل شيء، وهو بذلك منزه عن الشريك، والشبيه، والمنازع، والصاحبة، والولد، وعن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لايليق بجلاله.
وانطلاقا من الإيمان بالإله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، نصل إلى الإيمان بوحدة رسالة السماء، وبالأخوة بين الأنبياء، وبوحدة الجنس البشري كله، الذي يعود أصله إلى أب واحد، وأم واحدة، هما أبوانا آدم وحواء عليهما السلام.
وعلى امتداد وجود الإنسان على الأرض كانت هذه هي حقيقة رسالته، إن فهمها والتزم بتطبيقها حقق سعادته في الدنيا والآخرة، وإن فهم جزءا منها وأغفل الباقي أو أغفلها كلها خسر الدنيا والآخرة، وإن حقق في حياته الدنيوية من النجاحات المادية ماحقق، وهذا هو الخسران المبين.
وسوف أتناول في هذا المقال شرح سورة العصر، وأؤجل ومضة الإعجاز العلمي فيها إلى المقال القادم إن شاء الله، وقبل شرحي لهذه السورة الكريمة أرى ضرورة الاستئناس بأقوال عدد من المفسرين القدامى والمعاصرين.
من أقوال المفسرين في تفسير سورة العصر:
* ذكر ابن كثير -رحمه الله- ما مختصره: "والعصر": الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، وقال زيد بن أسلم: هو العصر، والمشهور الأول، فأقسمتعالىبذلك على أن الإنسان لفي خسر أي في خسارة وهلاك"إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات"فاستثني من جنس الإنسان عن الخسران: الذين آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم"وتواصوا بالحق" وهو أداء الطاعات، وترك المحرمات، "وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ" أي على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي، ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر.
* وذكر صاحبا الجلالين -رحمهما الله- ما نصه:(وَالْعَصْرِ): الدهر، أو: ما بعد الزوال إلى الغروب، أو: صلاة العصر(إِنَّ الإِنسَانَ): الجنس (لَفِي خُسْرٍ): في تجارته"إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات": فليسوا في خسران(وَتَوَاصَوْا): أوصى بعضهم بعضا "بالحق": الإيمان (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ): على الطاعة وعن المعصية.
وجاء بالهامش تعليق للشيخ محمد أحمد كنعان قال فيه: قوله: (في تجارته) لقد أبعد الجلال المحلي في تفسيره هذا، والأولى أن يقال: إن الإنسان خاسر وهالك إلا إذا آمن وعمل صالحا... إلخ، أي: لا تنفعه الدنيا وما عليها إذا لم يكن مؤمنا صالحا.
* وجاء في الظلال -رحم الله كاتبه برحمته الواسعة جزاء ما قدم- كلام رائع أختصره في النقاط التالية: فما الإيمان؟ إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباقي الذي صدر عنه الوجود، ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر، وبالنواميس التي تحكم هذا الكون، وبالقوى والطاقات المزخورة فيه، والانطلاق حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير، ومن حدود قوته الهزيلة إلى عظمة الطاقات الكونية المجهولة، ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله، ثم إن مقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة: التعبد لإله واحد، والربانية التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه، وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانينه، وكل مايربطه بالله أو بالوجود أو بالناس، ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق، والاستقامة على المنهج الذي يريده الله، والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله، والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم، عفو كريم، ودود حليم، وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة، والارتفاع عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا، إن الإيمان هو أصل الحياة الكبيرة، الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير، ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل، إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني، والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان، أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالهما صورة الأمة الإسلامية، والتواصي بالحق ضرورة، والتواصي بالصبر كذلك ضرورة، والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة.
وبعد استشهاد طويل من كتاب "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" للأستاذ أبوالحسن الندوي، ختم صاحب الظلال كلامه عن سورة العصر بقوله: وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق، إنه الخُسر (إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) طريق واحد لا يتعدد؛ طريق الإيمان والعمل الصالح وقيام الجماعة الإسلامية التي تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر، وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر، إنه طريق واحد، ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة (العصر) ثم يسلم أحدهما على الآخر، لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور الإلهي، يتعاهدان على الإيمان والصلاح، ويتعاهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور، ويتعاهدان على أنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور.
* وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن -رحم الله كاتبه- ما نصه: "والعصر"أقسم الله بصلاة العصر لفضلها؛ لأنها الصلاة الوسطي عند الجمهور، أو بوقتها، لفضيلة صلاته، كما أقسم بالضحى، أو بعصر النبوة لأفضليته بالنسبة لما سبقه من العصور أو بالزمان كله، لما يقع فيه من الأقدار الدالة على عظيم القدرة الباهرة. وجواب القسم:"إن الإنسان لفي خسر"أي إن جنس الإنسان لا ينفك عن خسران ونقصان في مساعيه وأعماله وعمره، أي إن الكافر لفي خسر، أي هلكة أو شر أو نقص(إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) استثناء متصل إذا أريد بالإنسان الجنس، ومنقطع إذا أريد به خصوص الكافر، والأعمال الصالحات تشمل جميع ما يعمله الإنسان مما فيه خير ونفع وبر.
(وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ) أوصي بعضهم بعضا بالتمسك بالحق، ومنه الثبات على الإيمان بالله وكتبه ورسله، والعمل بشريعته في كل عقد وعمل، وذلك هو الأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره، ولا زوال في الدارين لمحاسن آثاره. "وتواصوا بالصبر" أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر عن المعاصي، التي تميل إليها النفوس بالطبيعة البشرية، والصبر على الطاعات التي يشق على النفوس أداؤها، ومنها الجهاد في سبيله،وعلى البلايا والمصائب التي تصيب الناس في الدنيا، ويصعب على النفوس احتمالها، والله أعلم.
* وذكر أصحاب المنتخب -جزاهم الله خيرا- ما نصه: في هذه السورة أقسم الله -سبحانه- بالزمان لانطوائه على العجائب والعبر الدالة على قدرة الله وحكمته، على أن الإنسان لا ينفك عن نقصان في أعماله وأحواله، إلا المؤمنين الذين عملوا الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالتمسك بالحق، وهو الخير كله، وتواصوا بالصبر على ما أمروا به وما نهوا عنه.
* وجاء في صفوة التفاسير -جزى الله كاتبها خيرا- ما نصه: سورة العصر مكية، وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان، لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو شقاوته، ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره؛ أقسم -تعالى- بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الإنسان، وما فيه من أصناف العجائب، والعبر الدالة على قدرة الله وحكمته، على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان، إلا من اتصف بالأوصاف الأربعة وهي: (الإيمان) و(العمل الصالح) و(التواصي بالحق) و(الاعتصام بالصبر) وهي أسس الفضيلة، وأساس الدين، ولهذا قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: لو لم ينزل الله سوى هذه السورة لكفت الناس.
(وَالْعَصْرِ* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ*)أي أقسم بالدهر والزمان لما فيه من أصناف الغرائب والعجائب، والعبر والعظات، على أن الإنسان في خسران؛ لأنه يفضل العاجلة على الآجلة، وتغلب عليه الأهواء والشهوات. قال ابن عباس: "العصر" هو الدهر أقسمتعالىبه لاشتماله على أصناف العجائب، وقال قتادة: العصر هو آخر ساعات النهار، أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة الباهرة، والعظة البالغة، وإنما أقسم اللهتعالىبالزمان لأنه رأس عمر الإنسان، فكل لحظة تمضي فإنها من عمرك ونقص من أجلك، قال القرطبي: أقسم الله عز وجل بالعصر -وهو الدهر- لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها، وما بها من الدلالة على الصانع، وقيل: هو قسم بصلاة العصر لأنها أفضل الصلوات(إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) أي جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال، فهؤلاء هم الفائزون لأنهم باعوا الخسيس بالنفيس، واستبدلوا الباقيات الصالحات عوضا عن الشهوات العاجلات "وتواصوا بالحق" أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهو الخير كله، من الإيمان، والتصديق، وعبادة الرحمن (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)على الشدائد والمصائب، وعلى فعل الطاعات وترك المحرمات، حكمتعالىبالخسارة على جميع الناس إلا من أتى بهذه الأشياء الأربعة؛ وهي: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، فإن نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا كمل الإنسان نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وكمل غيره بالنصح والإرشاد، فيكون قد جمع بين حق الله، وحق العباد، وهذا هو السر في تخصيص هذه الأمور الأربعة.
من ركائز العقيدة في سورة العصر:
1- الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتنزيه الله -تعالى- عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
2- الالتزام بالصالحات من الأعمال.
3- التواصي بالحق.
4- التواصي بالصبر.
5- اليقين بأن الذين يلتزمون بهذه الضوابط الإيمانية -على قلتهم- هم الناجون في الدنيا والآخرة، وأن الذين لا يلتزمون -وهم الأكثرية الغالبة- سيخسرون الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين.
من الإشارات الكونية في سورة العصر:
1- القسم بالعصر وهو قسم يشمل الزمن كله، كما يشمل وقت العصر، أي الفترة الزمنية ما بعد الزوال إلى الغروب، أو صلاة العصر لفضلها.
2- الإشارة إلى ضلال أغلب الناس، واستثناء القلة الصالحة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتاريخ والواقع يؤكدان ذلك.
3- التأكيد أن الإنسان مخلوق اجتماعي بالفطرة، وهو ما أكدته جميع الدراسات المكتسبة.
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها، وسوف أتناول ذلك بشيء من التفصيل في المقال القادم إن شاء الله.
سورة العصر مكية، وآياتها ثلاث بعد البسملة، وعلى ذلك فهي من قصار سور القرآن الكريم، وقد سميت بهذا الاسم لاستهلالها بقسم من الله -تعالى- بالعصر، والله -سبحانه وتعالى- غني عن القسم لعباده، وعلى ذلك فقد فهم الذين تعرضوا لتفسير القرآن الكريم ورود القسم فيه بالتأكيد على أهمية الأمر المقسم به.
فما أهمية "العصر" الذي أقسم به ربنا -تبارك وتعالى- وهو الغني عن جميع خلقه، وعن القسم لعباده؟ وقد خصصنا هذا المقال للإجابة عن هذا السؤال الذي اختلف المفسرون في الإجابة عنه من بين قائل هو الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، أو الذي ينتهي فيه عمر الإنسان أو هو الدهر، أو هو قسم بالفترة فيما بعد الزوال إلى الغروب، أو بصلاة العصر لأهميتها وفضلها باعتبارها الصلاة الوسطى من الصلوات الخمس المفروضة عند جمهور العلماء، أو هو عصر النبوة الخاتمة لأفضليته على ما سبقه من عصور الجاهلية، أو هو قسم بالزمان كله، لما يقع فيه من الأقدار الدالة على عظيم القدرة الإلهية الباهرة، أو هو قسم بكل ذلك وغيره مما لا يعلمه إلا الله -سبحانه وتعالى-، ثم ننوي مناقشة لمحة الإعجاز العلمي في القسم بالزمان كله، وفي جواب القسم الذي يقول فيه ربنا -تبارك وتعالى-: "إن الإنسان لفي خسر ..."،وفي الاستثناء المتصل الذي يقول فيه -سبحانه وتعالي-:"... إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر".
هذا، وقد سبق لنا استعراض سورة العصر، وأقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة آياتها الثلاث، وتلخيص كل من ركائز العقيدة والإشارات الكونية فيها، ونوضح هنا عددا من جوانب الإعجاز العلمي والإنبائي والتقريري في هذه السورة المباركة.
من جوانب الإعجاز في سورة العصر:
أولا: من الإعجاز العلمي في القسم بالعصر:
مع الاختلاف بين المؤمنين من عباد الله -تعالى- والكافرين به عبر التاريخ تصارعت فكرتا خلق الكون والادعاء بأزليته؛ فكلما آمن قوم من الأقوام أو نفر من الناس بحقيقة أن هذا الكون الشاسع الاتساع، الدقيق البناء، المحكم الحركة، والمنضبط في كل جزئية من جزئياته، وفي كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، أو أن يكون وليد العشوائية والصدفة، نفث الشيطان في نفوس قوم أو أفراد آخرين بدعاواه الباطلة التي يسعي جاهدا لإضلال بني الإنسان بها والتي فحواها الادعاء بأزلية الكون، استدراجا للإنسان بنفي الخلق، والتنكر للخالق -سبحانه وتعالى- ونفي كل من البعث والحساب والجزاء، أي نفي الدين، ولذلك أشاع الملاحدة عبر التاريخ الادعاء الباطل بأزلية الكون، وامتلأت كتب الفلك وعلوم الأرض بشعارات كاذبة منها تلك الإشارة الباطلة التي اتخذت شعارا للعديد من المؤلفات والتي تقول: لا أثر لبداية، ولا إشارة إلى نهاية (There is no vestige of beginning nor sign for an end) حتى جاءت المعطيات العلمية لتكذب تلك الفرية الباطلة من مختلف مجالات العلوم المكتسبة (الفيزياء، الكيمياء، علوم الأحياء، علوم الأرض، الفلك، وحتى الرياضيات).
وقبل أن تطمس المعطيات العلمية المكتسبة دعاوى الملاحدة بأزلية الكون، جاء القرآن الكريم من قبل ألف وأربعمائة سنة مفصلا خلق السماوات والأرض، وخلق الحياة، وخلق الإنسان، وخلق كل شيء بالقول القاطع الجازم الذي لا لبس فيه:(ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) (الأنعام:102)ويتكرر التأكيد على هذه الحقيقة في مقام آخر بأمر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سورة الرعد حيث تقول:(...قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الوَاحِدُ القَهَّارُ)(الرعد:16)ويتكرر الفعل "خلق" بمشتقاته(252) مرة في كتاب الله لمزيد من التأكيد على حقيقة الخلق، وعلى طلاقة قدرة الخالق -سبحانه وتعالى-، وحينما حاولت الكنيسة البريطانية مقاومة المد الإلحادي الذي طغى على العالم الغربي منذ بدايات عصر النهضة خرج القس الأيرلندي جيمس أشرJames Ussher 1581-1656)) كبير أساقفة أرماغ (Archbishop of Armagh) في القرن السابع عشر الميلادي بدعوى أن خلق الكون قد تم في سنة4004 ق. م.، وظل هذا التاريخ مدونا في النص المخول تداوله من العهدين القديم والجديد حتى القرن التاسع عشر الميلادي(The Authorized Version of the Old and New Testaments)وكرَدَّة فعل لهذه الخرافة أخذ العلماء الغربيون في التأكيد على فكرة الكون الأزلي الأبدي أو ما يعرف باسم نظرية ثبات واطراد الكون(The Sready-State Theory) التي نادى بها في سنة 1948م كل من فريد هويل وزميلاه هيرمان بوندي وتوماس جولد(FredHoyle,HermanBondi&ThomasGold).
وبعد ذلك جاءت المعارف العلمية تترى مؤكدة حقيقة خلق الكون، وأن هذا الكون له بداية حاول علماء الفلك والفيزياء الفلكية تحديدها بوسائل علمية متعددة، منها علاقة معدل سرعة توسع الكون مع المسافة (أو ثابت هبل)، ومنها وسائل تحديد العمر المطلق بواسطة العناصر المشعة، ومنها تحديد أعمار أقدم النجوم فوصلوا إلى أن عمر الكون يتراوح بين (15) و(20) بليون سنة، وهو رقم ما كان ممكنا لأحد من الناس أن يتخيله -مجرد تخيل- قبل أواخر القرن العشرين.
وهذا العمر الطويل للكون فيه إشارة إلى عظم اتساع الكون؛ لأن الزمان والمكان أمران متواصلان، فإذا تعاظم الزمان اتسع المكان، وإذا نظر الفلكي إلى أجرام السماء البعيدة، فإنه ينظر إلى تاريخها القديم، وكلما بعد الجرم السماوي تقادم التاريخ، واهتزت القياسات.
وفي هذا العمر الطويل للكون إشارة إلى شيء من عظمة الخالق -سبحانه وتعالى- وتأكيد على أنه -سبحانه وتعالى- فوق كل من المكان والزمان، وفوق كل من المادة والطاقة(...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)(الشوري:11).
وعلماء الفلك اليوم يُجمعون على حتمية وجود مرجعية للكون في خارجه، وأن هذه المرجعية لابد أن تكون مرجعية واحدة لوحدة البناء في الكون كله، ولابد أن تكون مغايِرة مغايَرةً كاملة لجميع المخلوقين.
من هنا كان القسم القرآني بالعصر، أي: الزمان كله، الذي يعكس جانبا من جوانب طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، وعلى هيمنة الخالق العظيم، الواحد الأحد، الفرد الصمد، على جميع خلقه وعلى الكون بأسره.
وهذا لا يتنافى أبدا مع تعظيم الفترة من الزوال إلى الغروب، ولا ينتقص من فضائل صلاة العصر المفروضة فيها باعتبارها الصلاة الوسطى في عقد الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، ولا من فضائل عصر النبوة الخاتمة على ما سبقها من عصور الجاهلية والضلال؛ وذلك لأن من معجزات القرآن الكريم أن ترد فيه الكلمة -في غير ركائز الدين- فيفهمها أهل كل عصر بمعني من المعاني، وتظل هذه المعاني تنفرد باستمرار مع توسع دائرة المعارف المكتسبة في تكامل لا يعرف التضاد، ليبقى القرآن الكريم مهيمنا على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها، وهذا من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله.
ثانيا: من الإعجاز الإنبائي في قوله -تعالى-:
(إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ) يعلم ربنا -تبارك وتعالى- بعلمه المحيط أن الغالبية من الناس لن يكونوا مؤمنين، وأخبر بذلك خاتم أنبيائه ورسله -صلى الله عليه وسلم- من قبل ألف وأربعمائة سنة بقوله العزيز:(وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ)(يوسف:103)،وأكد ربنا -سبحانه وتعالى- هذه الحقيقة بقوله في سورة العصر:(إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ) (العصر:2).
والتاريخ كله يؤكد هذه الحقيقة التي يدعمها الواقع الراهن الذي يعيش فيه اليوم أكثر من بليون ملحد يشكلون حوالي16% من مجموع سكان العالم، بينما يشكل المسلمون حوالي25% والنصارى حوالي29%، والهندوس14%، والبوذيون5%، ومتابعو بعض التقاليد الصينية القديمة5%، ومتابعو التقاليد الإفريقية البدائية5%،والسيخ00,36%، واليهود00,22%، والباقي وقدره00,42% بعض الديانات الأخرى.
وإذا علمنا أن عدد المعلنين إلحادهم في عالم اليوم يزيد عن البليون نسمة، وأن أعدادهم في تصاعد مستمر، وأن الملتزمين من بين أصحاب الدين قد أصبحوا اليوم ندرة نادرة، لأن الغالبية الساحقة منهم تتخذ من الدين نوعا من الهوية والانتماء الاجتماعي فضلا عن كونه عقيدة، وعبادة، وأخلاقا، ومعاملات تُفهم فهما عميقا ويتم الالتزام بها التزاما دقيقا عن قناعة قلبية وعقلية كاملة، علمنا أننا نعيش في زمن من الفتن المتلاحقة.
إذا أدركنا هذا الواقع الكئيب، أدركنا ومضة الإعجاز الإنبائي في قول ربنا -تبارك وتعالى-: "إن الإنسان لفي خسر"لأن الحياة الدنيا مهما طالت فإن بعدها الموت، والقبر الذي إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، ومن بعد الموت البعث وأهواله، والحشر ومخاطره، والحساب الدقيق عن كل لحظة عاشها الإنسان على سطح الأرض، ثم الخلود في الآخرة إما في الجنة أبدا، أو في النار أبدا، وكل إنسان لا يستعد لهذه الرحلة الشاقة الاستعداد اللائق بها هو حتما"في خسر" أي خسران مبين في الدنيا والآخرة.
ثالثا: من الإعجاز التقريري في قول ربنا -تبارك وتعالى-:(إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر) (العصر:3):
هذا الاستثناء المتصل يشمل بني الإنسان جميعا، ويمثل قاعدة ثابتة راسخة في حياة الناس؛ وذلك لأن الإنسان مجبول على الإيمان بالله -تعالى- فإذا وجد الهداية الربانية الصحيحة التي تصله بالإيمان الفطري في داخله، فهم حقيقة نفسه، وتعرف على خالقه، وأدرك أبعاد رسالته في هذه الحياة الدنيا: عبدا لله، يعبده -تعالى- بما أمر، ويلتزم أوامره، ويجتنب نواهيه، ومستخلفا صالحا في الأرض يجتهد قدر طاقته في عمارتها، وإقامة شرع الله -سبحانه وتعالى- وعدله فيها حتى يلقى ربه وهو راض عنه، فيحقق بذلك نجاحه في الدنيا والآخرة، وذلك هو الفوز المبين.
ولكن الإنسان إذا لم يصل بجهده أو بهداية غيره إلى الدين الصحيح، فإما أن يملأ حاجته الفطرية إلى التدين بأي دين يرثه عن أبويه أو عن مجتمعه، أو يكتسبه بنفسه دون تمحيص كاف ليتأكد من صحة هذا الدين، أو أن ينتكس بالتنكر لخالقه، وللفطرة السليمة التي فطره الله عليها، فيرفض فكرة التدين رفضا كاملا كأغلب الضالين من أهل الأرض اليوم، وكلا الموقفين خاطئ تماما؛ لأنه سيجعل صاحبه يعيش في الدنيا عيشة التعساء، ويموت ميتة الخاسرين، ثم يبعث في الآخرة مع الأشقياء من أهل النار، وذلك هو الخسران المبين، ومن هنا كان هذا الاستثناء المتصل الذي يشمل البشرية جميعا، وكان هذا التقرير الإلهي المعجز الذي لا يخرج عليه فرد واحد من بلايين البشر الذين عاشوا وماتوا، ومن البلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، ومن البلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة.
فالحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على بعثة خير الأنام الذي بعثه الله -تعالى- بالدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.