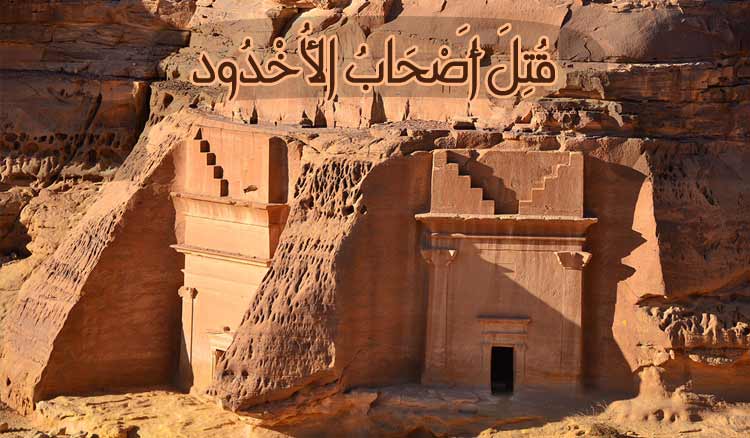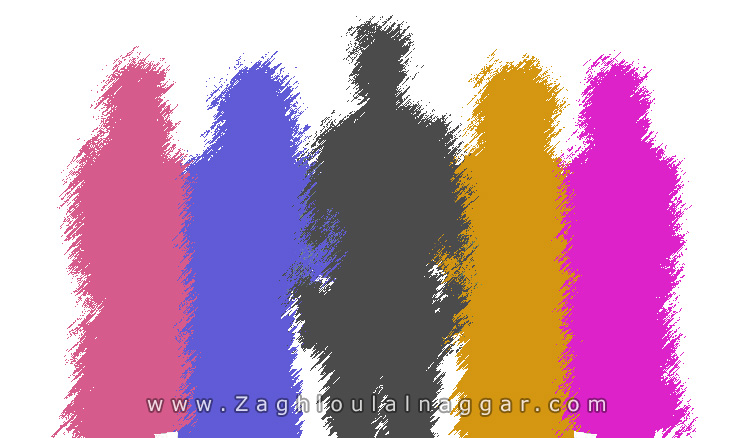
( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا*) - (النساء : 3)
هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في أوائل سورة النساء، وهي سورة مدنية، وآياتها مائة وست وسبعون (176) بعد البسملة، وهي رابع سورة في المصحف الشريف، ورابع أطول سور القرآن الكريم بعد كل من سورة "البقرة"، و"الأعراف"، و"آل عمران". وقد سميت السورة بهذا الاسم لكثرة ما ورد فيها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء. ويدور المحور الرئيسي للسورة حول قضايا التشريع لكل من المرأة ، والأسرة ، والبيت، والمجتمع، والدولة، وقضايا العبادات والجهاد في سبيل الله. هذا، وقد سبق لنا استعراض سورة "النساء"، وما جاء فيها من التشريعات الإسلامية، وركائز العقيدة، والإشارات الكونية، ونركز هنا على وجه الإعجاز التشريعي في رخصة تعدد الزوجات إذا كان هناك من الظروف الشخصية أو العامة، والقدرات الخاصة ما يبرر ذلك، وإلا فواحدة أو ما ملكت اليمين، خشية الوقوع في المظالم. الإعجاز التشريعي في رخصة تعدد الزوجات الزواج من سنن الفطرة التي شرعها الله- تعالى- إعفافا للإنسان وسكنا للزوجين تسوده المودة والرحمة، وحفاظا على استمرار النسل وعمران الأرض، ووسيلة للتواصل بين العائلات في المجتمع. وقد بلغ من حرص الإسلام على تطبيق سنة الزواج أن جعله كثير من فقهاء المسلمين واجبا يأثم المتثاقل عنه ما دام قادراعلى القيام بتكاليفه المادية والبدنية وذلك انطلاقا من قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- " النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم "، ومن قوله- صلوات ربي وسلامه عليه-: " من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء " . وقد أحاط الإسلام الزواج بكل ما يحفظ عليه استقراره واستمراره، ويحقق القصد منه في مودة وتراحم كاملين ، تحقيقا لقوله تعالى-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ً*) (الروم:21). والأصل في الزواج هو الإفراد، وذلك بدليل أن الله- تعالى- خلق لأبينا آدم- عليه السلام- زوجة واحدة، وأن نسبة الذكور إلى الإناث في المجتمعات العادية متقاربة جدا، ولكن الإسلام العظيم أباح رخصة التعدد إلى أربع زوجات كحد أقصى في الزمن الواحد إذا اقتضته الضرورة. واشترط على الزوج المعدد العدل بين زوجاته والتسوية بينهن في المبيت والسكن والرزق. وقد استغلت هذه الرخصة وسيلة للتهجم على شرع الله، علما بأن جميع المجتمعات البشرية من قبل كانت قد أباحت التعدد بلا حدود، مما تسبب في كثير من الفوضى والمظالم الاجتماعية، وجاء الإسلام ليضبط ذلك الأمر بمبرراته أولا، وبالعدل ثانيا، وبحد أقصى لا يتجاوز الأربع زوجات في الوقت الواحد، والدليل على ذلك ما يلي : 1)قول ربنا- تبارك وتعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا*) ( النساء : 3 ). 2)على إثر نزول هذه الآية قام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأمركل من كان معه أكثر من أربع نساء أن يمسك منهن أربع ويسرح الباقي وفي ذلك روى البخاري- بإسناده- أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم- وتحته عشر نسوة- فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم-: "اختر منهن أربعا ". 3)كذلك روى أبو داود- بإسناده- أن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمانية نسوة ، فذكرت ذلك للنبي فقال: "اختر منهن أربعا ". وعلى ذلك فإن الإسلام جاء ليحدد التعدد بأربع لا ليبيحه بغير حدود كما كان، ووضع قيودا منها القدرة على القيام بأعباء الزوجية والعدل، وإلا فواحدة أو ما ملكت اليمين، وحينئذ تمتنع الرخصة المعطاة. وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير- رضي الله عنه- أنه سأل خالته أم المؤمنين السيدة عائشة- رضي الله عنها وأرضاها- عن قوله- تعالى- :(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى...) فقالت : " يا ابن أختي ! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن" قال عروة: قالت خالتي أم المؤمنين السيدة عائشة : " وإن الناس استفتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعد نزول هذه الآية ، فأنزل الله- تعالى-: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ...) قالت أم المؤمنين السيدة عائشة: " وقول الله في هذه الآية الأخرى :(... وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ...*) رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال ". وفي التعليق على هذا الحديث لأم المؤمنين السيدة عائشة- رضي الله عنها- ذكر صاحب الظلال-رحمه الله رحمة واسعة- ما نصه: وحديث عائشة- رضي الله عنها- يصور جانبا من التصورات والتقاليد التي كانت سائدة في الجاهلية، ثم بقيت في المجتمع المسلم، حتى جاء القرآن ينهي عنها ويمحوها، بهذه التوجيهات الرفيعة ويكل الأمر إلى الضمائر، وهو يقول: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى...*) فهي مسألة تحرج وتقوى وخوف من الله إذا توقع الولي ألا يعدل مع اليتيمة في حجره، ونص الآية مطلق لا يحدد موضع العدل، فالمطلوب هو العدل في كل صوره وبكل معانيه في هذه الحالة، سواء فيما يختص بالصداق، أو فيما يتعلق بأي اعتبار آخر، كأن ينكحها رغبة في مالها، لا لأن لها في قلبه مودة، ولا لأنه يرغب رغبة نفسية في عشرتها لذاتها، وكأن ينكحها وهناك فارق كبير في السن لا تستقيم معه الحياة ، دون مراعاة لرغبتها هي في إبرام هذا النكاح، هذه الرغبة التي قد لا تفصح عنها حياء أو خوفا من ضياع مالها إذا هي خالفت عن إرادته... إلى آخر تلك الملابسات التي يخشى ألا يتحقق فيها العدل ... والقرآن يقيم الضمير حارسا، والتقوى رقيبا، وقد أسلف في الآية السابقة التي رتب عليها هذه التوجيهات كلها قوله: (... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً *). فعندما لا يكون الأولياء واثقين من قدرتهم على القسط مع اليتيمات اللواتي في حجورهم ، فهناك النساء غيرهن، وفي المجال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة ". والعدل المطلوب في حالة التعدد هو في المباشرة والمعاشرة والمعاملة والنفقة وفي كل ما يقع تحت طاقة الإنسان وإرادته لتحقيق العدل، أما فيما يتعلق بمشاعر القلوب فذلك خارج عن إرادة الإنسان واستطاعته، وفي ذلك يقول ربنا- تبارك وتعالى-: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيما ً*) ( النساء : 129 ). وتعدد الزوجات بجميع التحفظات التي قررهاالإسلام هو رخصة يقدمها شرع الله في عدد من الحالات الخاصة أو العامة دون أدنى غلو أو تفريط ، ومن هذه الحالات ما يلي : (1) إذا ثبت أن الزوجة عاقر ، لا يمكن لها أن تحمل وتلد، وللزوج رغبة فطرية في النسل ، فله أن يتزوج مع المحافظة على زوجته الأولى إذا قبلت بزواجه الثاني. (2) إذا مرضت الزوجة مرضا مزمنا يطول برؤه أو يستعصي على العلاج فيصبح الزواج الثاني أفضل من الطلاق. (3) إذا كان هناك أسباب صحية أونفسية تحول دون التوافق بين الزوجين مع رغبتهما في الإبقاء على رباط الزوجية. (4) إذا كان الزوجان متقاربان في السن، أو كانت الزوجة أكبر سنا من الزوج، فإن هذا الوضع يحدث فارقا في رغبات كل منهما الفطرية، وذلك لأن فترة الإخصاب عند المرأة تتوقف في أواخر العقد الخامس بينما مستمر في الرجل ألى أواخر العقد السابع أو تتجاوزه. (5) في حالات الحروب يزيد عدد الإناث البالغات زيادة ملحوظة على عدد الذكور البالغين، والحل الوحيد الذي يحافظ على سلامة المجتمع وطهارته من انتشار العلاقات غير المشروعة، وتوابعها النفسية والأخلاقية والاجتماعية المخيفة، هو التعدد، والبديل هو فساد المجتمع، أو إجبارالإناث البالغات على مخالفة الفطرة، وما يتبعها من متاعب نفسية وصحية مدمرة. وفي جميع هذه الحالات يوكل فقهاء الإسلام الأمر بقبول التعدد إلى المرأة، فإن قبلته- على أنه أقل الأضرار- دون أدنى إكراه فبها ونعمت، وإن رفضته (فتسريح بإحسان)، وذلك لأن الأمر في موضوع الزواج – ابتداء وتعددا – موكول إلى المرأة، تقبل منه ما ترى فيه راحتها النفسية، وترفض منه ما لا ترى فيه رضاها وقدرتها على التحمل. ومن معجزات القرآن الكريم أن أعلى حد لاختلال نسبة الإناث البالغات إلى الذكور البالغين لم تتعد أبدا نسبة (4-1) وذلك نتيجة للحروب الواسعة النطاق ( كالحربين العالميتين الأولى والثانية، وقد استمرت الأولى لأكثر من أربع سنوات متواصلة، وكان ضحاياها من القتلى أكثر من عشرين مليون نفس، ويقدر المشوهون بضعف هذا الرقم واستمرت الثانية لست سنوات متتالية وكان قتلاها أكثر من خمسة وخمسين مليونا من الأنفس، كان أغلبهم من الشباب المقاتلين والمدنيين ، ويقدر المشوهون بأضعاف هذا الرقم ). وحين يأتي القرآن الكريم ليحدد أعلى نسبة لتعدد الزوجات بأربعة ، يعتبر شهادة صدق على أن هذا تحديد من رب العالمين الذي لا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء ، وذلك لأن اختلال نسبة الإناث إلى الذكور لم تتجاوز تاريخيا نسبة (4-1)، بل دارت في حدودها. ولعل انتشار فوضى العلاقات الجنسية في مختلف المجتمعات غير المسلمة، وما يسودها من مختلف شور استباحة الأعراض، وزنا المحارم، والشذوذ الجنسي، والعزوف عن الزواج، أو المساكنة بين الجنسين دون أدنى رباط، والخيانات الزوجية المتبادلة بين الطرفين، والمخادنات السرية والعلنية، وما يرافق ذلك من الأبناء غير الشرعيين، وارتفاع معدلات الطلاق، وكثرة العوانس، وما يرافق هؤلاء من المآسي الإنسانية والمشاكل النفسية والاجتماعية، وضياع الأخلاق، وانحطاط المعايير، وانقلاب الموازين، وانتشار الجرائم، ولعل في ذلك- وفي ما هو أبشع منه من سلوكيات بشرية تعافها الحيوانات العجماء- ما يكفي دليلا قاطعا على وجه الإعجاز التشريعي في الآية التي اتخذناها عنوانا لهذا المقال والتي تحض على الزواج من اليتامى دون استغلال ضعفهن في ساحة اليتم، فيطمع في أموالهن أو في جمالهن دون الوفاء بحقوقهن كاملة غير منقوصة. فإن تعرض أحد المسلمين لهذه الفتنة فالأولى به أن يتزوج من غير اليتامى بواحدة أو بأكثر من واحدة، إلى الحد الأعلى بأربع- هذا إذا دعت ظروفه الخاصة أو الظروف العامة لمجتمعه إلى ذلك على أن يكون قادرا على تحقيقه وحمل تبعاته، وأن يحقق العدل في النفقة، والمعاشرة، والمباشرة، والمعاملة بين أزواجه. فهناك حد لا يتجاوزه المسلم هو أربع زوجات، وهناك قيد هو إمكان تحقيق العدل، وإلا (... فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) من الإماء. والتشريع الإسلامي هو صياغة ربانية خالصة، ولذلك فهو يتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة ولا يعارضها، ويلبي كل ضرورياتها واحتياجاتها بكفاءة وعدل وموضوعية، مع المحافظة على كرامة الإنسان وحقوقه (ذكرا كان أو أنثى ) في كل أمر من الأمور وفي كل بيئة من البيئات، وفي كل زمان ومكان. والزواج من الأمة المملوكة فيه رد لاعتبارها، ومحافظة على كرامتها الإنسانية، لأن الزواج هو من مؤهلات التحرير من الرق لها ولنسلها من بعدها- حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج- فهي منذ اليوم الذي تلد فيه لسيدها تصبح أما لولده، وبالتالي يمتنع عليه بيعها ، وصارت حرة وصار ولده منها كذلك حرا منذ لحظة مولده. كذلك عند التسري بها، فإنها إذا ولدت أصبحت أم ولده، وامتنع بيعها ، وصارت حرة، وصار ولده منه كذلك حرا، وهذا ما كان يحدث عادة. فالزواج والتسري كلاهما من طرق التحرير العديدة التي شرعها الإسلام للتخلص من نظام العبيد الذي كان منتشرا في مختلف أجزاء الأرض قبل بعثة المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وجاء الإسلام بتشريعاته الإنسانية لتحرير العبيد من ربقة الرق. والضرورة التي أباحت الاسترقاق في الحرب، هي ذاتها التي أباحت التسري بالإماء أولا للمعاملة بالمثل، لأن مصير الحرائر العفيفات من المسلمات اللائي كن يقعن في أسر الكفار والمشركين كان شرا من هذا المصير! وثانيا للإيمان بأن هؤلاء الأسيرات المسترقات من الكافرات والمشركات لهن مطالب فطرية لا بد وأن تلبى ما دام نظام الرق قائما إما بالزواج أو بالتسري لأن هذه المطالب لا يمكن إغفالها في أي نظام إنساني واقعي يراعي فطرة الإنسان، وإلإ شاعت الفاحشة في المجتمع، وهذا ما يأباه الإسلام ويحرمه تحريما قاطعا. ونظام الرق كان شائعا في مختلف المجتمعات الإنسانية قبل البعثة المحمدية الشريفة، وكان الرقيق من النساء هن السبب الأول في إشاعة حالة من الانحلال الأخلاقي، والفوضى الجنسية التي لا ضابط لها ولا رابط حين لم يكن أمامهن سبيل لإشباع حوائجهن الفطرية في دائرة التسري مع السيد أو الزواج منه ألا التفحش والابتذال الذي أفسد كثيرا من المجتمعات الإنسانية التي كان منها مجتمع الجزيرة العربية في زمن الجاهلية، وجاء الإسلام لتطهير تلك المجتمعات من أدران الزنا، والخنا، والفحش، والتسيب في السلوك، وفي تحريم مختلف العلاقات غير المشروعة بين الجنسين. أما الاستكثار من الإماء عن طريق الشراء من النخاسين فليس من الإسلام في شئ، وإن وقع فيه بعض المسلمين في القديم، وذلك لأن دين الله الذي يعتبر الناس جميعا إخوة وأخوات ينتهي نسبهم إلى أب واحد هو آدم- عليه السلام- وإلى أم واحدةهي حواء- عليها من الله الرضوان- لا يمكن أن يسمح باستعباد الأخ لأخيه ولا أخته، ولذلك جاء بالحلول المنطقية لتصفية جريمة الاسترقاق التي كانت سائدة في مختلف بقاع الأرض . وبهذا الاستعراض يتضح وجه الإعجاز التشريعي في الآية القرآنية الكريمة التي اتخذناها عنوانا لهذا المقال، والله يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل.