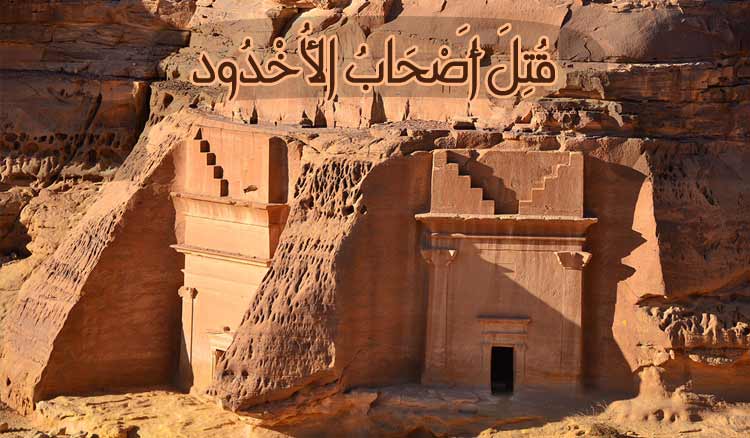(...وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً*) - (الأحزاب:38)
هذا النص القرآنى الكريم جاء فى مطلع النصف الثانى من سورة "الأحزاب"، وهى سورة مدنية، وآياتها ثلاث وسبعون (73) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الأسم لورود الإشارة فيها إلى غزوة الأحزاب، والأحزاب تكونت من كفار قريش الذين جاءوا من جنوب بلاد الحجاز، وممن تجمع معهم من القبائل من مثل قبيلتى غطفان وأشجع الذين جاءوا من شمال بلاد الحجاز، وتحزبوا لمحاربة المسلمين، وقاموا بمحصارة المدينة المنورة فى السنة الرابعة للهجرة، فأمررسول الله- صلى الله عليه وسلم- بحفر خندق حول المدينة دفاعا عنها ضد حصار الكفار والمشركين الذين دام لحوالى الشهر، ثم أرسل الله- تعالى- على أحزاب الكفار المحاصرين للمدينة ريحا عاصفة، وجنودا من الملائكة، فاضطروا إلى فك الحصار، وإلى الفرار بعيدا عن المدينة طالبين النجاة، فرجعوا إلى ديارهم بخيبة الأمل. ويدور المحور الرئيسى لسورة " الأحزاب" حول الوصف التفصيلى للغزوة التى سميت باسمها، وما كان فيها من خوف واضطراب، وما تم فى نهايتها للمسلمين من نصر تحقق به وعد الله. وبالإضافة لذلك أوردت السورة عددا من التشريعات والآداب الإسلامية وتحدثت عن الأخرة وأهوالها’ ونصحت بضرورة الالتزام بتقوى الله’ وختمت بالحديث عن الأمانة التى حملها الإنسان، ولم يطق حملها أى من السماوات والأرض والجبال. هذا وقد سبق لنا استعراض سورة "الأحزاب"، وما جاء فيها من التشريعات، وركائز كل من العقيدة والعبادات والأخلاق، ونورد هنا الحديث عن ومضة الإعجاز التشريعى فى الدعوة إلى الأيمان بقدر الله. من أوجه الإعجاز التشريعى فى النص الكريم يقول ربنا- تبارك وتعالى- فى محكم كتابه: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً )¬¬¬ ( الأحزاب:38). نزلت هذه الأية الكريمة فى التأكيد على أنه ما كان على النبى- صلى الله عليه وسلم – من حرج فيما فرض الله – تعالى – له أى: فيما أحل الله – سبحانه وتعالى – له، وأمره به من الزواج بالسيدة / زينب بنت جحش – رضى الله عنها – بعد أن كان زيد بن حارثة قد طلقها، من أجل أن يشرع الله – جل جلاله – تحريم التبنى، ويؤكد على جواز التزوج بمطلقات الأبناء المتبنين تأكيدا على عدم شرعية عملية التبنى التى كانت سائدة فى زمن الجاهلية، ولا يزال الكثيرون من الجهلة بالدين يمارسونها إلى يومنا هذا. وفى هذا السياق يروى ابن عباس – رضى الله عنهما – أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثة – رضى الله عنهما – فاستنكفت منه، وقالت: أنا خير منه حسبا، فأنزل الله – تعالى -: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ).( الأحزاب : 36). وإن كانت الآية أمرا عاما بطاعة أوامر الله – تعالى – وأوامر رسوله – صلوات الله وسلامه عليه – فى كل أمر من الأمور، فإذا حكم الله ورسوله بشئ’ فليس لأحد من الخلق مخالفته، ولا اختيار لأحد ههنا، ولا رأى ولا قول. وتستمر الآيات بعد ذلك بخطاب من الله – تعالى – موجه إلى خاتم أنبيائه ورسله – صلى الله عليه وسلم – يقول له فيه: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً* مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً).( الأحزاب:37-38). وتشير هاتان الآيتان الكريمتان إلى أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان قد زوج زيد ابن حارثة بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية بأمر من الله – تعالى – بعد أن أنعم الله عليه بالإسلام وبمتابعة الرسول الخاتم – صلى الله عليه وسلم – ثم أنعم عليه رسول الله بعتقه من الرق وهو من أسرة عريقة، ولكنه كان قد أسر صبيا صغيرا وبيع رقيقا فى أسواق مكة فاشترته السيدة خديجة – عليها رضوان الله- ووهبته لرسول الله – صلى الله عليه وسلم- فأعتقه. وبعد زواج دام قرابة السنة وقع بين الزوجين خلاف فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فجعل رسول الله يوصيه بأن يمسك عليه زوجه وأن يتقى الله فيها، ولكن الله – تعالى – كان قد أعلم نبيه بأن ابنة عمته زينب بنت جحش ستكون من أزواجه، من قبل أن يتزوجها، وكان الله – تعالى- قد أمره أن يزوجها من زيد بن حارثة ثم أنها سوف تطلق منه ليتزوجها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى يبطل ظاهرة التبنى، ويبيح للأباء الزواج من مطلقات الأدعياء، وأن يعوض السيدة زينب بنت جحش عن الزواج من عبد طليق وهى من سادات قريش، وأن يعوض ذلك العبد الطليق الذى كان قد أسر فى طفولته وبيع رقيقا فى أسواق مكة وهو من أشراف قومه. ولذلك عندما جاءه زيد شاكيا من زوجته أوصاه بالمحافظة على بيته وهو يعلم أن ذلك لن يكون، ومن هنا قال له الله – تعالى – ( وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ). وكان ذلك كله بتقدير من الله – تعالى – حتى يؤمن كل مسلم ومسلمة بقضاء الله وقدره كركن من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر’ وبالقدر خيره وشره’ ولذلك قال – تعالى -: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ). ( الأحزاب:38). ومن معاني هذا النص الكريم أنه: ما كان على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من حرج فيما أحل الله – تعالى – له وأمره به من الزواج بابنة عمته زينب بنت جحش بعد أن طلقها دعيه زيد بن حارثة من أجل التشريع أولا بتحريم التبنى، وثانيا بجواز زواج الآباء من مطلقات أدعيائهم وهو محرم فى حالة مطلقات أبنائهم الشرعيين. وقوله- تعالى – (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ). يؤكد أن هكذا كان حكم الله- تعالى – فى جميع الأنبياء الذى بعثوا قبل خاتمهم أجمعين، فما كان الله – سبحانه وتعالى – يأمرهم بأمر فيجدوا حرجا فى صدورهم من تنفيذ أمر الله وذلك لأن أمر الله – تعالى- كائن لامحالة’ لا تستطيع قوة فى الكون رفضه. وهذا هو صلب الإيمان بقضاء الله وقدره، والإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. والقضاء والقدر هما أمران متداخلان يكمل أحدهما الآخر، فالقضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال فى الأزل، أما القدر فهو الحكم فى وقوع الجزئيات للكليات التى قدرت فى الأزل، وقد يكون الأمر بالعكس، بمعنى أن القدر من التقدير أى: ما قدره الله – تعالى- فى الأزل أن يكون فى خلقه، وعلى ذلك يكون التقدير سابقا على القضاء. وعلى أية حال فالقضاء والقدر أمران لاينفك أحدهما عن الآخر، ويكمل أحدهما الآخر حتى إذا أطلق أحدهما منفردا فإنه يشمل الآخر، ولعلهما أمر واحد يصف القرار الإلهى الذى لايحده أى من حدود المكان والزمان، ولا تقوى أية إرادة للخلق المكلفين من اعتراضه، ومن هنا كانت ضرورة التسليم به والرضى عنه مهما كان ظاهره فى غير صالح الإنسان، لأن قضاء الله – تعالى – هو الحق كله والعدل كله والرحمة كلها وهو قضاء مقضى وحكم مبتوت لاراد له ولامبدل ولامغير، ومن هنا وجب الرضى به والقناعة بعدله فمن صفات الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، العليم المحيط بكل شئ والقدرة المطلقة على كل شئ والإرادة الحاكمة لكل شئ فلا يخرج شئ عن علمه ولا يقف عائق أمام طلاقة قدرته، ولا تستطيع إرادة خلقه المكلف الوقوف أمام إرادته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لن يكون. وهذا من ركائز التوحيد الذى علمه ربنا – تبارك وتعالى – لعبده آدم – عليه السلام – لحظة خلقه، وعاشت به البشرية عشرة قرون كاملة وذلك لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : " كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة الحق" ( أخرجه الحاكم فى المستدرك). وفى ذلك يروي ابن عباس – رضى الله عنهما " أن رجالا صالحين من قوم نوح هلكوا فوسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ، وتنسخ العلم عبدت" ( أخرجه البخارى فى صحيحه).وكانت هذه هي أول وثنية في تاريخ البشرية. وبعث الله – سبحانه وتعالى- مائة وأربعة وعشرين ألف نبى، واصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا كلهم دعوا إلى الإسلام القائم على الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وعلى التوحيد الخالص لله الخالق – سبحانه وتعالى- ( بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد). والإيمان بالقضاء والقدر جزء لا يتجزأ عن الإيمان بالله – تعالى- وحده. وتنزيهه عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله، والتسليم بإحاطة علمه – تعالى- : بكل شئ، ونفاذ إرادته فى كل أمر، وتحكم قدرته فى جميع خلقه. ومن الإعجاز التشريعى فى قوله – تعالى-: (...وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً). أن الإيمان بالقضاء والقدر تسليم لحكم الله وإرادته، إنطلاقا من الإيمان الراسخ بأنه لا سلطان في هذا الوجود كله لغير الله – تعالى شأنه- فكل شئ يجرى بتقديره، وحسب مشيئته وإرادته وتدبيره، فالله – تعالى- لاراد لقضائه، ولامعقب لحكمه، ولاغالب لأمره، وإذا آمن العبد منا بذلك عاش سعيدا على هذه الأرض وإن كان أفقر الناس، وأضعف الخلق، وأحوج المخلوقين، وإذا لم يؤمن بذلك كان أتعس الناس، وإن كان أكثرهم مالا وولدا، وأعزهم سلطانا وأقواهم بنية. ومن هنا تأتى ومضة الإعجاز التشريعى فى الأمر بالرضا بقضاء الله وقدره. وهذا لايتعارض أبدا مع حقيقة أن الإنسان مخلوق مكرم، أكرمه الله – تعالى- بالعقل الذى يميز به بين الخير والشر، وبالإرادة الحرة التى يستطيع أن يسلك بها أيا من الطريقين، ولذلك فهو محاسب على اختياره الذى يتخذه بإرادته الحرة، علما بأن الإرادة الإنسانية داخلة فى دائرة علم الله وقضائه وقدره، وهذا لاينتقص من أجر الصالحين، ولايبرر فساد المفسدين، لأن لكل مخلوق مكلف أن يختار الصلاح أو الفساد بإرادته الحرة، ومن هنا وجب الاستحقاق بالثواب أو بالعقاب لأن الحياة الدنيا هى دار تكليف واختبار وابتلاء، ولا يتم ذلك إلا إذا كان المكلف مطلق الحرية فى الاختيار بين الحق والباطل وبين الإصلاح فى الأرض أو الإفساد فيها. والإنسان – كأحد الخلق المكلفين – يتحرك فى حياته الدنيا داخل دائرتين متمركزتين عليه: أولاهما هى دائرة إرادته الحرة التى هو مخير فيها بين الاستقامة على منهج الله أو الخروج عليه، وعلى ذلك فهو مكافأ أو معاقب على أساس من اختياره. وثانيتهما هي دائرة قضاء الله وقدره والتي لا سلطان له عليها، ولارأى له فيها، ومن ثم فلا يحاسب على ما يحدث له فيها، ولكن عليه إذا كان مؤمنا بالله إيمانا صادقا أن يرضى بقضاء الله وقدره رضا كاملا، وأن يسلم بأن فيه الخير كل الخير، حتى لو ظهر له أنه في غير الصالح بالمقاييس البشرية المحدودة لأن فى ذلك تسليم لله الخالق بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وإيمان بشمول علمه، وكمال عدله، ونفاذ إرادته، وطلاقة قدرته. والإيمان بالقضاء والقدر لايتنافى أبدا مع الأخذ بالأسباب التى أمرنا بالأخذ بها، مع التوكل على الله – تعالى- حق التوكل، والإيمان بأن بيده- سبحانه وتعالى- وحده ملكوت كل شئ. والإنسان الذى يؤمن بقضاء الله وقدره يتحرر من العبودية لغير الله – سبحانه وتعالى- لأنه يؤمن بأنه لاسلطان فى هذا الوجود لغير الله الخالق البارئ المصور، مقدر الأقدار، ومصرف الأمور، وإنسان هذا إيمانه لا تبطره النعمة، ولا تهده المصيبة، ولذلك قال فيه المصطفى – صلى الله عليه وسلم -: " عجبا لأمر المؤمن !! إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن إصابته ضراء صبر’ فكان خيرا له" ( أخرجه مسلم في صحيحه). فالرضا بقضاء الله وقدره يهدئ النفس، ويطمئن القلب، ويدفع بالطاقات الإنسانية من أجل حسن القيام بواجبات الاستخلاف فى الأرض برضا وسكينة، وراحة وطمأنينة بأن قضاء الله – تعالى – نافذ لا محالة، وهو لا يأتي إلا بخير. وهنا تتضح ومضة الإعجاز التشريعي في قول ربنا – تبارك وتعالى-: (...وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً) حتى يرضى كل مؤمن بقضاء الله وقدره فى تسليم وسلام تامين كاملين فيسعد ويسعد من حوله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على بعثة خير الأنام – صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين- وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.