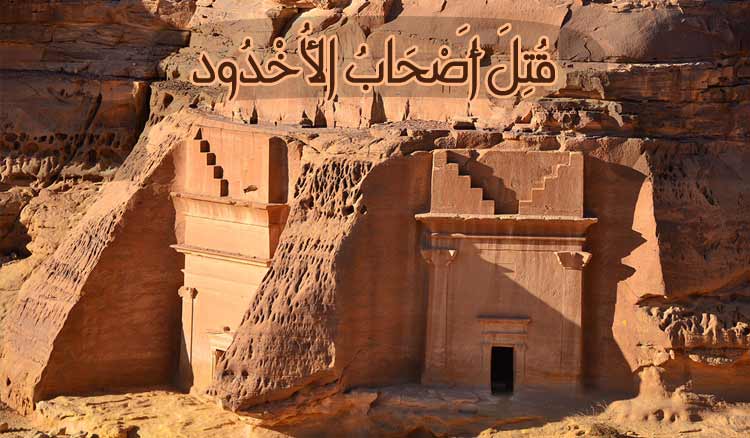( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ) - (الأنفال: 30) ج1
هذه الآية الكريمة جاءت في أواخر النصف الأول من سورة "الأنفال" , وهي سورة مدنية , وآياتها خمس وسبعون (75) بعد البسملة, وقد سميت بهذ الاسم (الأنفال) جمع (نفل) بالفتح وهو الزيادة أو الأمر الثانوي , إشارة إلى الغنائم التي غنمها المسلمون أثناء معركة بدر الكبرى . وقد سميت غنائم الحرب بالأنفال احتقارا لشأنها مقارنة بالأهداف الرئيسة للجهاد في سبيل الله ومنها رد الظالم , وحماية الدين , والعرض, والأرض, وطلب الشهادة في سبيل الله , وهي قضايا تهون أمامها أية مكاسب مادية من مثل الغنائم . ويدور المحور الرئيسي لسورة "الأنفال" حول عدد من التشريعات الإلهية للقتال في الإسلام , انطلاقا مما جرى في غزوة بدر الكبرى . هذا وقد سبق لنا استعراض هذه السورة الكريمة , وما جاء فيها من التشريعات وركائز العقيدة الإسلامية , ونستعرض هنا لمحة الإعجاز الإنبائي في الآية الكريمة رقم (30) من سورة "الأنفال" والتي اتخذناها عنوانا لهذا المقال . من أوجه الإعجاز الإنبائي في الآية الكريمة يقول ربنا- تبارك وتعالى- في سورة "الأنفال" مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله- صلى الله عليه وسلم- : ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ *)(التوبة:30). وسورة التوبة مدنية بمعنى أن هذه الآية الكريمة أنزلت بالمدينة أي بعد حادثة الهجرة بقرابة السنتين لتستعرض الفارق الكبير بين وضع المسلمين في مكة قبل الهجرة , وموقفهم في المدينة المنورة بعد الهجرة. فقد كان وضعهم في مكة قبل الهجرة وضع المستضعف المضطهد من قبل مشركي مكة, وأصبح وضعهم في المدينة موضع القوة والعزة والمنعة بعد انتشار الإسلام بين أهل المدينة وتعهدهم بأن يمنعوا رسول الله مما يمنعون منه أنفسهم, وتحقق هذا التحول في حياة المسلمين بعد انتصارهم في معركة بدر الكبرى. والآية الكريمة التي نحن بصددها تصور هذه النقلة الهائلة التي تمت بتوفيق الله ورعايته, وبحسن التدبير والتخطيط من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وبقوة إيمان أصحابة بنبوته ورسالته, وشدة حبهم له, وتفانيهم في الوفاء له ولدعوته. وهنا تأتي هذه الآية الكريمة لتصور موقف مشركي مكة وهم يبيتون لرسول الله- صلى عليه وسلم- ويتآمرون عليه لمنعه من اللحاق بالمسلمين في المدينة حتى يمنعونه من تكوين قاعدة إسلامية يمكن أن تحاربهم وأن تنتصر عليهم. وفي التعليق على هذه الآية الكريمة (رقم 30 من سورة الأنفال) يذكر الشهيد سيد قطب : ما نصه : " إنه التذكير بما كان في مكة, قبل تغير الحال وتبدل الموقف , وإنه ليوحي بالثقة واليقين في المستقبل, كما ينبه إلى تدبير قدر الله وحكمته فيما يقضي به ويأمر ..., ولقد كان المسلمون الذين يخاطبون بهذا القرآن أول مرة, يعرفون الحالين معرفة الذي عاش ورأى وذاق . وكان يكفي أن يذكروا بهذا الماضي القريب , وما كان فيه من خوف وقلق, في مواجهة الحاضر الواقع وما فيه من أمن وطمانينة.... وما كان من تدبير المشركين ومكرهم برسول الله- صلى الله عليه وسلم- في مواجهة ما صار إليه من غلبة عليهم , لا مجرد النجاة منهم! لقد كانوا يمكرون ليوثقوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويحبسوه حتى يموت؛ أو ليقتلوه ويتخلصوا منه؛ أو ليخرجوه من مكة منفيا مطرودا... ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله؛ على أن يتولى ذلك المنكر فتية من القبائل جميعا؛ ليتفرق دمه في القبائل؛ ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلها, فيرضوا بالدية , وينتهي الأمر !" وتروي لنا كتب التاريخ الإسلامي أنه بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية انتشر الإسلام في يثرب حتى لم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وقد دخله دين الله, فأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مسلمي مكة بالهجرة إليها, ورأى مشركوا قريش في ذلك خطرا جسيما عليهم لتركز المسلمين فيها واتخاذهم من الذين أسلموا من أهل يثرب منعة ومن أرضها حصنا, فحذروا من خروج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إليهم لأنه لو وصل إلى تلك المدينة لجمع المسلمين لمحاربة أهل الكفر والشرك والضلال في شبه الجزيرة العربية, وكان على رأسهم وفي مقدمتهم قريش , فتنادوا إلى اجتماع في دار الندوة (وهي دار قصي بن كلاب التي كان مشركو قريش لا يقضون أمرا إلا فيها) من أجل التشاور في أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في محاولة لمنعه من الوصول إلى يثرب بأي ثمن. وبعد تداول الأمر , تكلم أبو البحتري بن هشام مقترحا حبسه حتى الموت , فرفض اقتراحه خشية أن يعيرهم العرب بذلك, فاقترح الأسود بن عمرو نفي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ألى خارج مكة , فردوا عليه اقتراحه قائلين: ليس هذا برأي , ألم تروا حسن حديثة , وقوة منطقه , فإذا حل عند قوم لا يلبث أن يستولي على نفوسهم, ويحل في سويداء قلوبهم. بعد ذلك تحدث أبو جهل (عمرو بن هشام, زعيم بني مخزوم) قائلا: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد؛ قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى , شابا, جليدا, نسيبا, وسيطا فينا, ثم نعطي كل واحد منهم سيفا صارما , فيمدوا إليه (أي يذهبون حيث محمد) فيضربونه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه , فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل , فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا , فرضوا منا بالعقل (أي بالدية) فعقلناه لهم. استحسن الحضور رأي أبي جهل , وقرروا إخراجه إلى حيز التنفيذ . ولذلك قال- تعالى-: (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا...) وفي التعليق على ذلك ذكر الإمام أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: "...تشاورت قريش ليلة بمكة , فقال بعضهم : إذا أصبح فاثبتوه بالوثاق- يريدون النبي- صلى الله عليه وسلم- وقال بعضهم :بل اقتلوه .وقال بعضهم بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك؛ فبات علي-رضي الله عنه- على فراش رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وخرج النبي حتى لحق بالغار. وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي فلما أصبحوا ثاروا إليه, فلما رأوه عليا رد الله- تعالى- عليهم مكرهم , فقالوا : أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري ! فاقتصوا أثره, فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم, فصعدوا في الجبل, ومروا بالغار, فرأوا على بابه نسج العنكبوت, فقالوا : لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه... فمكث فيه ثلاث ليال". وفي ذلك يروي ابن إسحق قائلا : " فأتى جبريل-عليه السلام- رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال؛ لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما كانت عتمة اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه, فلما رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: "نم على فراشي, وتسج ببردي هذا الأخضر, فنم فيه, فإنه لن يخلص إليك شئ تكرهه منهم", وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ينام في برده ذلك إذا نام ". وأضاف ابن اسحق قائلا :" وخرج عليهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأخذ حفنة من تراب في يده , وأخذ الله- تعالى- على أبصارهم عنه حتى لا يرونه , فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو قوله- تعالى- ( يس * وَالْقُرْآنِ الحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * تَنزِيلَ العَزِيزِ الرَّحِيمِ * لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ * لَقَدْ حَقَّ القَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ * إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَداًّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَداًّ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ *)(يس: 1-9), حتى فرغ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من هؤلاء الآيات, ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. فأتاهم آت ممن لم يكن معهم, فقال: ما تنتظرون ههنا ؟ قالوا: محمدا؛ قال خيبكم الله! قد والله خرج عليكم محمد, ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا, وانطلق لحاجته, أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب, ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرحوا ذلك حتى أصبحوا, فقام علي- رضي الله عنه- عن الفراش, فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا " . وفي ختام هذه الآية الكريمة (رقم 30 من سورة "الأنفال") يقول ربنا- تبارك وتعالى-: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ *) وفي ذلك تجسيد لمكر مشركي قريش وتآمرهم على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليثبتوه بالوثاق أو بالإثخان بالجراح حتى يقعدوه تماما عن الحركة وهو كناية عن السجن إلى الموت, أو يقتلوه بأيدي ممثلين لجميع القبائل حتى يتفرق دمه بينهم فتقبل عشيرته الدية, ويرتاح المشركون من أمره, أو يقومون بنفيه إلى خارج مكة حتى يرتاحوا من المصادمة مع دعوته. والآيات تخاطب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مشيرة إلى فضل الله- تعالى- عليه في هذه المحنة قائلة له: إنهم يدبرون لك هذا التدبير السيئ والله من ورائهم محيط يدبر لك السلامة من بين أيديهم, ويمكر بهم, ويبطل كيدهم, ويفشل مخططاتهم وهم لا يشعرون. وشتان بين تدبير الخالق وتدبير المخلوقين , فتدبير الله- تعالى- هو الأعز والأعلى والأغلب في كل حال والله قادر على أن يرد كيد المشركين إلى نحورهم, وأن يحبط مكرهم, ويفشل كل خططهم, وفي المقابل يحفظك يا محمد من شرورهم وكيدهم ومخططاتهم, وأن ينجيك من كل ذلك ويعاقب مشركي قريش على وقوفهم في وجه دعوة الله بتكبر وتجبر واستعلاء كاذب وظلم بين, ويكتب لك يا محمد النصر عليهم والتمكين في الأرض حتى تقيم دولة الإسلام التي تحمل أمانة التبليغ بدين الله إلى أهل الأرض أجمعين. وهذه الآية الكريمة تذكر المسلمين في كل وقت بفضل هجرة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى المدينة وهي تمثل ثاني أهم حدث في تاريخ الإنسانية, بعد بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين- صلى الله عليه وسلم- تلك البعثة التي أعاد الله- تعالى- بها نور الهداية الربانية إلى أهل الأرض من جديد بعد أن كانوا قد فقدوها تماما بضياع كل صور الوحي السابقة, وغرق البشرية في بحار من المعتقدات الفاسدة, ومن كثرة صور الشك والشرك والفساد والضياع, وغمر الأرض ببحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمار, وبالمظالم المستترة والمعلنة, والتحلل الكامل من جميع ضوابط السلوك. والآية الكريمة تمثل وجها من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله حيث قام جبريل- عليه السلام- بإخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بكل ما تداوله صناديد قريش في دار الندوة, وبالموعد الذي ضربوه لحصار بيته من أجل قتله, وبأمر الله- تعالى- له بالهجرة في تلك الليلة وإلا كيف كان ممكنا له النجاة من هذه المؤامرة الخسيسة. والدروس المستفادة من هجرة رسول الله هي أكثر من أن تحصى أو أن تعد, ولكن يكفي أن نشير إلى أنه كان منها ما يلي: (1) التأكيد على حتمية الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل, وعلى أن الحق لا ينتصر لمجرد كونه حقا بل يحتاج إلى المؤمنين به الذين يجاهدون في سبيله, ويبذلون الغالي والرخيص من أجل الانتصار له, والدفاع عنه, وإعلاء كلمته في الأرض. (2) ضرورة إحكام التخطيط في كل أمر, والأخذ بالأسباب بعد جميل التوكل على الله- تعالى- والثقة في تأييده ونصره. (3) اليقين في معية الله- تعالى- ورعايته لعباده المؤمنين به, والمتوكلين حق التوكل عليه, بعد الأخذ بالأسباب كلها, ثم الرضى بقضاء الله وقدره. (4) ضرورة الوفاء بالأمانات وبالعهود والمواثيق تحت جميع الظروف, مع المؤمن والكافر على حد سواء. (5) التأكيد على إمكانية استخدام التورية الصادقة في أوقات الأزمات. (6) ضرورة الإيمان بوقوع المعجزات للأنبياء والمرسلين, ووقوع الكرامات لعباد الله الصالحين. (7) اليقين بنصر الله رغم ما قد يلقاه المسلم من الابتلاءات والشدائد لأنها هي الطريق إلى النصر. وعلى المسلمين في كل احتفال بذكرى هجرة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يتذكروا ما تعرض له هذا النبي والرسول الخاتم, وأصحابه الكرام من ابتلاءات وشدائد من اجل نشر دين الله في الأرض, وإقامة دولته في المدينة المنورة, وتربية جيل من المسلمين الصادقين تحت ظل هذه الدولة الناشئة, والانطلاق منها إلى اجتثاث جذور الكفر والشرك والضلال من كل جزيرة العرب, ثم التحرك المدروس بعد ذلك لفتح نصف المعمورة في أقل من قرن من الزمان, وحمل الإسلام العظيم ألى ملايين البشر في رقعة امتدت من الصين شرقا ألى بلاد الأندلس غربا بالكلمة الطيبة, والحجة البالغة, وبمكارم الأخلاق وأفضل السلوكيات. وإذا كانت هجرة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مقيدة بحدود الزمان والمكان, فإن مبادئ الهجرة تبقى في زمن الفتن الذي نعيشه تجسيدا لحتمية فرار المسلم إلى الله ورسوله من وسط ضلال الحضارات المادية المعاصرة وذلك انطلاقا من أقوال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- العديدة والتي نذكر منها ما يلي: (1) "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية " ( متفق عليه ). (2) "....والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه " ( متفق عليه). (3) " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة , ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " ( كل من الإمامين ابو داود والنسائي ). (4) "لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو " ( كل من الأئمة أحمد, النسائي وابن حبان). (5) "من مات ولم يغز, ولم يحدث نفسه به, مات على شعبة من النفاق" (الإمام مسلم). وإذا وعى مسلمو اليوم الدروس المستفادة من هجرة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لخرجوا من حالة التمزق والتشرذم التي يعيشونها اليوم والتي أدت بهم إلى التخلف والتراجع والانهزام في كل منحى من مناحي الحياة, ولانتقلوا من مرحلة الاستضعاف والإذلال والاستغلال والاضطهاد التي يرزحون تحتها اليوم إلى مرحلة القوة والمنعة والنصر المؤزر بتأييد من الله-تعالى-, وذلك بجمع الكلمة, ولم الشمل, والتوحد على دين الله, ولو حققوا ذلك لعادوا إلى قيادة العالم من جديد, وتمكنوا من إنقاذه من الهاوية التي يتردى فيها اليوم في ظل تقدم علمي وتقني مذهل, وانحسار ديني وأخلاقي وسلوكي مدمر, وما ذلك على الله بعزيز, وهو – تعالى – يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين.