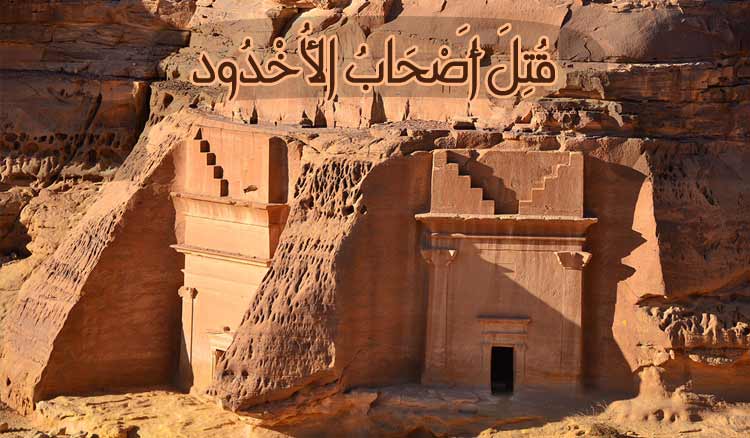(إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ) القلم:17
من أسرار القرآن
مقالات جريدة الأهرام المصرية
(إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ) القلم:17
بقلم الأستاذ الدكتور/ زغلول راغب النجار
(348)
هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في أواخر الثلث الثاني من سورة القلم، وهي سورة مكية، وآياتها اثنتان وخمسون(52) بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لاستهلالها بقسم القلم وبما يسطرون، وذلك تعظيما للعِلم، وتكريما لأدواته.
ويدور المحور الرئيس للسورة حول عدد من ركائز العقيدة الإسلامية، وفي مقدمتها الإيمان بالله -سبحانه وتعالى- ربا واحدا أحدا، فردا صمدا، بغير شريك، ولا شبيه، ولا منازع، ولا صاحبة، ولا ولد، والتصديق بجميع أنبيائه ورسله، وعلى رأسهم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد بن عبدالله، سيد الأولين والآخرين من بني آدم، واليقين بحتمية الآخرة، ومافيها من أهوال البعث، والحشر، والعرض، والحساب، والجزاء بالخلود إما في الجنة أبدا، أو في النار أبدا.
هذا، وقد سبق لنا استعراض سورة القلم وماجاء فيها من ركائز العقيدة، ونركز هنا على وجه من أوجه الإعجاز في ذكر قصة أصحاب الجنة؛ للاعتبار بما جاء فيها من دروس وعبر.
من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر أصحاب الجنة:
جاءت هذه القصة في الرد على أبي جهل(عمرو بن هشام) الذي رفض الإسلام عصبية وتكبرا وتجبرا، وانطلاقا من كونه زعيم بني مخزوم من قريش، وكون المصطفى-صلى الله عليه وسلم- من بني عبد مناف، وذلك كما ورد من قصته مع كل من الأخنس بن شريق، وأبي سفيان بن حرب، حين خرج ثلاثتهم منفردين يستمعون القرآن خفية من تلاوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على مدار ثلاث ليال، وهم في كل ليلة يتواعدون على عدم العودة؛ خشية أن يراهم الناس فيقع في نفوسهم شيء من الميل إلى قبول الإسلام دينا.
فلما سأل الأخنس بن شريق أبا جهل رأيه فيما سمع من القرآن الكريم كان جوابه: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، وكنا كفرسَي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتي ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه.
وكان من دوافع رفض مشركي قريش دين الإسلام، أن التوحيد الذي جاء به هذا الدين السماوي يهدم كل صور الشرك التي كانوا هم وأهل الأرض -في غالبيتهم الساحقة- قد وقعوا فيها إلى آذانهم حتى ضلوا وأضلوا، وملؤوا الأرض انحرافا وفسادا.
وكان من دوافع مقاومة كفار قريش ومشركيها لدعوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عدد من الاعتبارات الاجتماعية، التي كان في مقدمتها الخوف من انتزاع الزعامة من بين مشايخهم في بيئة قبلية تجعل للزعامة الاجتماعية كل الاعتبار، وذلك لأن رسول الله -مع علو قدره، وشرف نسبه في قريش من قبل أن يأتيه الوحي- لم تكن له زعامة اجتماعية فيهم، بينما كانت الزعامات الاجتماعية موزعة بين مشايخ كل من مكة والطائف، وكانوا يخشون انتزاع تلك الزعامات من بين أيديهم بانتشار الإسلام، ولذلك قال ربنا -تبارك وتعالى- على لسانهم:(وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف:31]، خاصة وأن القرآن كان يتنزل بالدعوة إلى التوحيد الخالص لله -تعالى-، وبتسفيه كل صور الشرك من عبادة الأصنام والأوثان والقمر والنجوم والكواكب والملائكة والجن، وبتسفيه كل الطقوس المبتدعة المرافقة لذلك، ومن هنا بدأ الكفار والمشركون في مقاومة الدعوة الإسلامية، وفي التطاول على شخص النبي الكريم، وفي تعريض القلة التي آمنت معه إلى أشد ألوان التعذيب، وأغراهم بذلك كثرة أموالهم وأولادهم، ونسوا أن ذلك كله من نعم الله عليهم، وما أشنع أن تقابل نعم الله -تعالى- بالكفر به وبالتطاول على رسوله وعلى أوليائه.
وللرد على ذلك يضرب القرآن الكريم لهم مثلا بقصة أصحاب الجنة، وهي قصة تُذكِّر بعواقب البطر بالنعمة، وبأخطار مقابلتها بالاستعلاء والكبر بدلا من الحمد والشكر، وتؤكد أن ماوهبهم الله -تعالى- من أموال وبنين هو من ضروب الابتلاء لهم، كما ابتُلِيَ أصحاب هذه القصة التي تكشف أحداثها عما وراءها من تدبير الله وحكمته، وإحاطة علمه وطلاقة قدرته.
وتبدأ القصة بشيخ صالح كانت له جنة في الأرض، عبارة عن بستان ذي شجر يستر الأرض لكثرته، وقد تسمى الأشجار الساترة نفسها جنة أرضية، وكان هذا الشيخ الصالح يُخرِج زكاة ثمار جنته بانتظام حتى وافاه الأجل المحتوم، وجاء أولاده من بعده فأغراهم الشيطان بالامتناع عن إخراج زكاة زروعهم، وأغواهم بذلك وزينه في قلوبهم، فبيَّتوا الاستئثار بثمار تلك الحديقة عند تمام نضجها.
وعندما قرب موعد جني الثمار اجتمعوا بليل، وقرروا الخروج إلى حديقتهم في الصباح الباكر، ليقطفوا ثمارها ولا يتركوا منها شيئا لمستحقي الزكاة، على عكس ما كان يفعل أبوهم من قبل، وتعاهدوا على تنفيذ ذلك وأقسموا عليه، وباتوا ليلتهم وقد عقدوا النية على تنفيذ مخططهم الشيطاني، ولكن القرار الإلهي بتدمير جميع ثمار ذلك البستان كان قد سبقهم إليه، فنزل ببستانهم بلاء محيط، فأصبح كالذي قد صرمت(أي: قطعت) ثماره، فلم يبق منها شيء، وفي ذلك يقول القرآن الكريم:(إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ* وَلاَ يَسْتَثْنُونَ*فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ* فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ) [القلم:17-20].
وفي الصباح الباكر نادى بعضهم على بعض من أجل الاستعداد لتنفيذ المخطط الذي أجمعوا كلمتهم عليه، ثم تحركوا في تستر وصمت كاملين حتى لا يدركهم أحد من الفقراء والمساكين، فيتبعهم إلى البستان؛ أملا في الحصول على شيء مما يَجمعون، كما كانوا ينالون ذلك على زمان أبيهم من قبل، وفي ذلك تقول الآيات:(فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ * فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ * أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا اليَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ * وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ) [القلم:21-25].
و(الحرد) هو القصد أو التنحي، ومعنى ذلك أنهم في الصباح الباكر ساروا إلى بستانهم سرا، متنحين عن قومهم، عازمين على تنفيذ المخطط الذي رسموه، وعلى تنفيذ ماأجمعوا أمرهم عليه، قاصدين ذلك ومصممين عليه، وهم واثقون من قدرتهم على تنفيذه، وهو جمع ثمار البستان منفردين لا يراهم أحد من الناس، حتى لا يعطوا المساكين من قومهم شيئا منها، ولكنهم عندما وصلوا إلى بستانهم لم يعرفوه؛ لأنهم وجدوا ثماره قد قطعت بالكامل حتى لم يبق منها ثمرة واحدة على فرع من فروعه، أو على الأرض من حول أشجاره، فظنوا أنهم قد ضلوا الطريق إلى بستانهم الذي لم يعرفوه؛ لتجريده من ثماره تجريدا كاملا، ثم بالنظر فيما حولهم من معالم أدركوا أنه بستانهم، وتنبهوا إلى أنهم قد حُرموا ثماره جزاء تآمرهم الشيطاني؛ من أجل حرمان المساكين من حولهم من الحق الذي شرعه الله -سبحانه وتعالى- لهم، فقال أرجحهم عقلا وأعدلهم رأيا من بينهم: هلا ذكرتم الله وتبتم إليه، وتضرعتم له أن يغفر لكم خطاياكم بما بيَّتم من نوايا سيئة، وقررتم حرمان مساكين قومكم من حقهم في ثمار بستانكم الذي شرعه الله -سبحانه وتعالى- لهم، فنالنا من العقاب الإلهي مانالنا!
وكان قد نصحهم من قبل ألا يفعلوا ذلك فعصوه، فأخذ بعضهم يلوم البعض الآخر على ماكانوا قد خططوا له وأقسموا عليه، بقصد حرمان المساكين حقهم الذي فرضه الله -تعالى- حتى فاقوا من غفلتهم فتابوا إلى بارئهم، واستغفروه، وأنابوا إليه، وفي ذلك تقول الآيات:(فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ* فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ * عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ* كَذَلِكَ العَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [القلم:26-33].
فتاب هؤلاء الأبناء أصحاب الجنة إلى الله–تعالى-بعد أن رأوا عذاب مانع زكاة الزروع بأعينهم، وتعلق الآيات بأن العذاب الذي نزل بهم بإهلاك ثمار بستانهم وهم في قمة الثقة بقدرتهم على قطعها وجمعها، فإن إهلاك كفار قريش ومشركيها ليس بالأمر المستغرب، خاصة وأنهم كانوا قد فجروا في كفرهم وشركهم، وبالغوا في معارضة الإسلام، وفي إيذاء خاتم أنبياء الله ورسله، وفي تعذيب القلة التي آمنت به في بدء دعوته.
وما أحوج المسلمين اليوم إلى تأمل هاتين القصتين: قصة أصحاب الجنة الذين قد قرروا عدم إخراج زكاة زروعهم، فعاقبهم الله -تعالى- بحرمانهم من ثمارها، ثم تابوا إليه، واستغفروه، وعادوا عن غيهم، وقصة كفار قريش ومشركيها، وقد أغرتهم وفرة أموالهم وكثرة أولادهم على رفض الحق الذي جاء به نبيهم الصادق المصدوق، والأمين المؤتمن عندهم، فتهددهم ربهم بسَوق قصة أصحاب الجنة إليهم، تهددهم بأن ما يملكون من مال وعيال قابل للزوال في لمح البصر، أو في أقل من ذلك، وفي الوقت ذاته يطمئن المسلمين بأن كل ما يرونه على الكفار والمشركين من آثار النعم في المال والعيال إنما هو ابتلاء من الله -تعالى- له عواقبه في الدنيا إذا لم يؤدوا حقه، ولم يتوبوا إلى بارئهم وينيبوا إليه، ويتطهروا من دنس الكفر والشرك؛ ولذلك يتهددهم القرآن الكريم بقول الحق -تبارك وتعالى- إليهم:(كَذَلِكَ العَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [القلم: 33].
ومن الدروس المستفادة من قصة أصحاب الجنة مايلي:
1- ضرورة محاربة الإنسان في ذاته لأمراض شح النفس والبخل؛ لأن في المال حق معلوم للسائل والمحروم، ولأن الذي لايخرج هذا الحق الشرعي معرض للعقاب الإلهي.
2-أن عدم إخراج الحق الشرعي من الزكاة مثل زكاة المال والزروع هو صورة من صور غمط الحق وبطر النعمة الذي لايرتضيه الله -تعالى- من عباده، وكما يكون ذلك الانحراف عن الحق مرضًا في الأفراد يكون في المجتمعات التي إن ضلت عن منهج الله -تعالى- وانحرفت عنه فإن الله -تعالى- يبتليها بالحرمان من نعمه حتى تفيق من غيها، وتصحح من أخطائها، وتعود إلى كنف الله.
3-أن من وظائف ابتلاءات الناس في الدنيا هو إيقاظهم من غفلتهم وإحياء ضمائرهم؛ من أجل تصحيح مسار حياتهم.
4-أن الابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير، فليست إفاضة المال والجاه والسلطان هي دوما من علامات رضى الله، وليس الفقر والمرض وغيرهما من الابتلاءات هي دوما من علامات سخط الله.
5-أنه على كل إنسان أن يكتشف أخطاءه في هذه الحياة الدنيا، وأن يقوم بتصحيحها فور اكتشافها، وباب التوبة مفتوح لكل تائب إلى أن يغرغر، ومن هنا كان واجب العقلاء من عباد الله أن يداوموا على الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله.
6-أن تكافل المجتمع الإسلامي هو فريضة من الله يجب على كل مسلم أن يقوم بها، وأن يساعد على إحيائها بكل مايستطيع من جهد ومال؛ لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة.
7-أن مايخفى على العباد لا يخفى على رب العالمين الذي يكافئ المحسن على إحسانه، ويجازي المسيء بإساءته، وأن الله سريع الحساب.
8-أن الحرمان الحقيقي في الدنيا هو في البعد عن أوامر الله؛ لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة، ولايمكن للزارع فيها أن يفلح بغير الهداية الربانية.
9-أن الرزق من الله -سبحانه وتعالى-، وكل ماهو من الله لا يمكن أن يُطلب بمعصية، بل لابد أن يُطلب بتقديم الطاعات له.
من هنا كان في استعراض قصة أصحاب الجنة وجه من أوجه الإعجاز التاريخي في كتاب الله؛ لأنه لم يرد لها ذكر في أي من كتب الأولين، ولو أنها جاءت على عادة القرآن الكريم من أجل الاستفادة بما جاء فيها من دروس وعبر دون الدخول في تفاصيل الأسماء، والأنساب، والأماكن والأزمنة.
والله يقول الحق، وهو يهدي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين.